كتب: محمد هشام
يفارق أصدقاءه وبشعر بعدم ارتياح كالعادة؛ إذ إنهم لا يضيفون إليه شيئاً وهو كذلك، هي جلساتٍ يومية فقط للسمر والضحك، أما النقاش والجدال والبوح ليس له موقعٌ من تلك الصداقة. يمضي طول الطريق يفكر: وما جدوى مثل تلك العلاقات خاصةً وانها تقتطع جزءً كبيراً من وقته؟! يشعر بأنه محاطٌ بكثيرين، إلا أنه في النهاية أقرب لنفسه من أقرب الأقربين؛ ألم يقولوا صاحب الكل وحيد؟! وما أدراكم بتلك الحالة لدى شخصٍ يشعر أيضاً بأنه عبء على نفسه؟!
وجاءته وقتها الحاجة تُلِح إلحاحاً شديداً لأن يتحدث .. لأن يقول ما يعجز أن يقوله لمحطينه الذين يلتقي بهم كل يوم .. ليقول أيضاً بعضاً مما يعجز أن يقوله لنفسه .. حتى ولو كان هذا البوح لغريب، طالما القريب لا يفهم ولا يعطي المساحة لشخصٍ يقابله لأول مرة؛ أليس البشر أقران؟! وهم يشعرون كثيراً بمعاناة بعضهم البعض طالما المسافات بعيدة، واللقاءات عابرة.
وجاءت في مخيلته –وقتها- زيارة أديب البرازيل باولو كويلو إلى إيران، ومقولته التي حركت سكونه بعنفٍ عندما قرأها لأول مرة: “قابلتُ هناك أصدقاء رأيتهم لأول مرة!” .. وقطع شرود ذهنه وشتات أفكاره منظرٌ يبدو أن الطبيعة قد شاركت في صنعه .. ويبدو أن المشتاقين للبوح –أمثاله- يلتقون دوماُ في سُفُن الحيرة والشتات والإحساس بالضياع .. ويكأن الحكيّ شريطٌ حديديّ مُثَبَت على جوانب الطرق، فمهما اعوجّ أو طال؛ فمصيره إلى التقاءٍ ووصول كقضبان السكك الحديدية.
رآها تُشبِك يديها بأرجلها الاثنتين .. تنظر إلى السماء يائسة .. بائسة .. فلا يبذل المار جوارها مجهودًا لأن يعرف أنها قد ألمت بها الملمات والأرزاء .. ولابد وأن يتحمل من ينظر إلى وجهها عناء الإشفاق عليها والشعور بالتعاطف معها والرغبة في مساعدتها في الخروج من ها الحالة الكئيب .. ولما لا؟! فالإنسان نفسه مٌتَوَقة دوماً لمساعدة الآخرين ذوي الملامح الوديعة .. تلك الوجوه الهادئة التي تشارك الطبيعة سكونها في ليالي الربيع الصافية. يبدو أنه لو وجد الإنسان أحد أقرانه في ضيقٍ وكدر، وفي نفس الوقت لو وجد تلك الخصلات الذهبية المتدلية على خصرها وعيناها الزرقاوان وبشرتها الفضية التي تليق بسكان المتوسط، لقرر على الفور أن يأخذ زمام المبادرة في مساعدة الغريب الوديع على القريب السئيل الشكّاء!
علّ تلك المساعدة أو تلك المحاولة تكون ببوحٍ يُضاف إلى بوح؛ فسماع الحكي مفتاحٌ لحكيٍ آخر باستفاضةٍ وارتياح .. حتى أنك تجد نفسك كثيراً لكي تقول ما يثقل عليك وعلى قلبك، تجدك مُضطراً لأن تسمع نديمك، وتتظاهر بأنك تُنصِت باهتمام لحديث قرينك، إلى أن تنقلب دفة الحديث تنتظر رد اهتمامك في الأول بإصغاء .. وتنتظر أن يكون بوحك واستمرارك في الحديث بصبرٍ من مستمعك ودون ضيقٍ أو شعورٍ بالملل مع مشاركتك الحلول وما يريح من الكلام والمواقف والخبرات.
فتجرأ وذهب إليها؛ جالساً بجوارها .. وحاول أن يجتذب منها الحديث اجتذاباً بالاتكاء بجوارها على ركبتيه؛ محاولاً أن يُقلِد جلستها مع عينٍ تميل يساراً كالذئاب ليرى كيف ستستقبل الفتاة هذا الموقف الغريب؟! وبدا له من أول وهلة أنها لم تُبد استغراباً من تصرف جليسها، بل قامت بمبادرته بابتسامةٍ خفيفة تنُم عن قبولها بعرضه لإمكانية مشاركته الحديث معها. وتبعت ضحكتها بتعبيرٍ على وجهها تُفصِح عن دهشةٍ قد عمدت إلى تصنعها حتى تعيد للمفاجأة هيبتها ووقارها .. وعلى الأقل حتى تعطي من القيمة الكبيرة ومن الجلال لتلك اللحظة التي سبقت جلستهما سوياُ، وكانت –اللحظة- مليئة بالشوق والخوف والرغبة ومشاعر مختلطة لا تُنذِر بارتياح.
وكلٌ قد قرأتَه في نظرات عينيه منذ بداية الجلسة! ولما لا؟! فمجالسو الطبيعة والمنفردون بالنفس والهائمون في السماء في الليالي المقمرة، والمتفردون بالصبابات والذكريات هم أولى الناس بمعرفة دواخل الناس .. إنهم يستمدون ذكاءهم من معاشرة النفس والاقتراب منها أكثر من الآخرين؛ وتلك الرؤية جليةُ دوماً بوضوح!
وأخذ ينظر في عينيها وتنظر إليه دون حديث .. تنظر إلى السماء ويراقب النجوم .. تتأفف كإعلانٍ عن أنه قد حل وقت إنزال جبال الهموم والعذابات لتلقي بها إليه، ويمسك هو برأسه من يسارها ويضم يديه إلى ركبتيه؛ محاولاً الإعلان عن استعداده لاستقبال الحديث وبعدها الفضفضة إليها والحكيّ. ويتعجب المراقب لهما، ومن يقرأ السطور التي لابد وأن تبدأ في الإسهاب وحمل دفة الكلام إلى القارئ ليرى طلاسم الشخصيات وقد زالت غشاواتها وقد تعرى كلاهما بجوار الآخر وأمام كاتبهما على الأقل. إلا أنهما لم يحركا ساكنين على أوضاعهما لأكثر من ساعة .. ولم يبادر كلاهما الآخر بما يويل القيود عن الحديث .. بل يكتفون بنظراتٍ إلى الحياة أمامهما مع حملقاتٍ في السماء. عله علاجٌ جديد لمن ألم به كدرٌ وحَزَن .. ويبدو أنهما قد اتفقا –كلاهما- على أن يتمردا على اتجاهات الطب النفسي التي لا تعرف حلولاً للمشكلات والغموم اللهم إلا بالبوح وإخراج ما في الصدور والقلوب ..
ومرت دقائق أخرى وساعات وهما في نفس المكان يتخذون نفس أوضاع الجلوس، للدرجة التي كانت تتناثر فيها دموعها احياناً ويقابلها هو بابتسامة؛ فتبتسم! ويتناثر العرق على جبينه ويهتز متوتراً؛ غير راضٍ عن صمته وصمتها، فيتناسى نفسه وقتها؛ فعلها تكون هي في حاجةٍ إليه وإلى مساعدته؛ ولكنهما اتفقا في صمتٍ ان يصمتوا .. ويبدو أنهما قد اتفقا على أن الحديث الدائم للناس ما أسهله؟! وأن كبح جماح اللسان اللهم إلا للحاجة صعب .. وأخيراً هم في حاجةٍ إلى صمتٍ دون كلمةٍ أو همهمة وهذا الأكثر صعوبة. إلا أنهما قد رأوا في الحالة الأخيرة سهولة كسهولة الحديث والبوح والحكي باستفاضةٍ وانتشار ..
وهدأت نفسهما وودعت! وأخرج كتاباً من حقيبته كان على مقربة من الانتهاء منه إلا خمسين صفحةٍ فأكمله .. وأخرجت هي لوحةً كانت تنقصها رتوشٌ أخيرة فأتمتها في وقتٍ أكثر من المفترض لها؛ متحايلةً على الوقت حتى يطول أكثر في حضرة صمتهما الرائع وسكوت نديمها الذكيّ .. وانتهى من قرائته وانتظر! ولم تلحظ هي ها الانتظار، حتى انتهت من اللوحة ورأته يحدق النظر فيها بإعجاب خاصةً انها كلها مرسومةً بقلمٍ رصاصٍ مَدَرَج دون ألوانٍ أو زيوت؛ ويكأن اللوحة تشاركهما أيضاً جلال الصمت وهيبته فتمردت على كل الألوان ..
وأمسكت يمينه بيسارها؛ فتشابكت الأصابع .. دون أن تتطابق الأيدي على بعضها .. وهنا جاءت لحظة الحديث الحاسمة التي كان ينتظرها القارئ بشوق أكثر منهما، قال لها: صمتك ذكيّ، وقالت: سكوتُك وابتسامتك أروع حديثٍ قد سمعته!
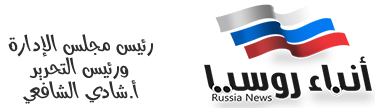 وكالة أنباء روسيا الإخبارية
وكالة أنباء روسيا الإخبارية



