نشرت جريدة القاهرة، في عددها رقم 1045 الصادر بتاريخ 28 يوليو 2020 وهذه الدراسة عن كتاب”الحركة السلفية الوهابية في الاتحاد الروسي وأوضح المهندس”أحمد بهاء الدين شعبان” بأن هذا الكتاب العظيم القيمة،والمُعنون بـ «الحركة السلفية ـ الوهابية في الاتحاد الروسي»، للدكتور «عمرو محمد الديب»، والذى أصدرته مؤخراً «المؤسسة المصري الروسية للثقافة والعلوم»، مجرد صورة بانوراميه، أو استعراض تقريري روتيني لأوضاع الإرهاب وانتشاره كالخلايا السرطانية في الجسد الروسي، وخطط الصراع الدامي في مواجهته وآليات مقاومته، في دولة «روسيا الاتحادية»، وحسب، وإنما يعرض بتركيزٍ وافٍ لـ «ميكانيزمات» توليد هذه الكيانات التخريبية الخطرة، وآليات اصطناعها، ومصادر وتمويلها، وأجهزة توجيه خطط عملها، والدور الذي لعبته، وتلعبه دول لها أغراض خبيثة، ومصالح خبيئة، وأخرى حباها الله بسعةٍ من الرزق بلا تعب، ووفرة هائلة من أموال النفط تجري بدون انقطاع، استخدمت جانباً، ليس بالقليل منها، باعتراف قادتها، مؤخراً، لخدمة مصالح دول إمبريالية كبري، أمرتها فاستجابت، وراحت ترعي بذور الشر حتي نمت، وأتت ثمارها السامة، وكادت تلتهم الأخضر واليابس!.
«أسلمة روسيا: مسألة وقت»!
و «روسيا الاتحادية» وطنٌ كبير، يقطنه أكثر من 143 مليون مواطن، ويجمع تحت رايته 85 كياناً فيدرالياً، مُكوناً من جمهوريات ذات استقلال ذاتي، وأقاليم ومُقاطعات، ومدن فيدرالية، وتبسط هذه الدولة هيمنتها علي أراضٍ شاسعة، تُمَثِّلُ ثُمن مساحة الأرض المأهولة بالسُكَّان في العالم، والتي تُقَدَّرُ بأكثر من 17 مليون كيلومتراً مُرَبَّعاً. وقسمٌ مُعتبرٌ من قاطني هذا الاتحاد، في حدود
15 ـ 16% من إجمالي عدد هؤلاء السُكان، يعتنقون الديانة الإسلامية (الأغلبية من السُنّة، ونحو 10% من الشيعة).
وبسبب ثقافة المجتمعات الإسلامية، وإقبالها على الإنجاب، تضاعفت نسبة المسلمين في روسيا، بين عامي 2000 و2014، ثلاث مرّات تقريباً، (من 5,5 إلى 16%)، وهناك توقُّعات بتضاعف نسبتهم، خلال الـ 15 عاماً القادمة، لتصل إلى 30% من مجموع السُكّان، وهناك مَن يرى أن المسلمين سيمثلون نحو 80% من السُكَّان، بحلول عام 2050، وهو ما دعي البعض إلى التصريح بأن: «أسلمة روسيا مسألة وقت ليس إلَّا»!
وكما يذكر المؤلف، فإن مُعظم السُكَّان المُسلمين يعيشون في جمهوريتي «باشكيرستان» و»تتارستان»، ويتركزون في المنطقة المُمتدة بين البحر الأسود وبحر قزوين، ومعظم هؤلاء المُسلمين من شعوب «الشيشان»، و»البلقار»، و»الإنجوش»، و»الشركس»، والعديد من شعوب «داغستان». أمّا في محيط نهر الفولجا، فيعيش «البولغار» و»الباشكير»، ومعظمهم من المُسلمين؛ كما توجد نسبة كبيرة من السُكَّان المُسلمين في منطقتي «أورينبورج»، و «أستراخان»، وفي «سيبيريا»، وبعض المناطق الأخرى في روسيا؛ ويرصد المؤلف صعود موسكو، عاصمة روسيا، لأن تصبح «أكبر مدينة إسلامية في أوروبا»، فوِفقاً لبعض التقديرات، «هناك ما بين مليون ونصف إلى مليوني مسلم بين سُكَّانها»؛ وفضلاً عن ذلك فهناك أعداد كبيرة من المُسلمين القادمين من آسيا الوسطى، وأفريقيا، والهند والشرق الأوسط، يستقرون بجانب المُسلمين الذين يعيشون لقرون في موسكو، أو الذين يعيشون في «القوقاز» ومناطق أخرى من روسيا.
اجتياح إرهابي وجائحة «وهابية»!
وقد تأثرت حركة التطرُّف الديني في الدولة الروسية، تأثراً شديداً بتصاعد موجات «التطرُّف الإسلامي» التي ضربت مُحيطنا الجغرافي: المنطقة العربية و»الشرق الأوسط»، كما يذكر المؤلف، بدءاً من انتصار ما يُسَمَّي بـ «المقاومة الإسلامية» في أفغانستان، والتي حقَّقت عام (1989) انسحاب القوات السوفييتية من البلاد، ثم ردة الفعل المؤلمة علي نشر القوات الأمريكية في المملكة العربية السعودية خلال أزمة (1990 ـ 1991)، وبروز التيارات الإسلامية في الانتفاضة الفلسطينية (1987)، وتصاعد مد الأصولية المُتطرِّفة في مصر، وقبلها بالطبع الثورة الإيرانية وأصدائها، واغتيال الرئيس الأسبق «أنور السادات»، وغيرها من أحداث شبيهة، شديد الأثر على «تقوية الروح المعنوية، وتقوية حُجة المتشددين بين الإسلاميين».
والأدهي تَمَثَّلَ في تَبَنِّي بعض المسئولين الكِبار، مثلما فعل رئيس جمهورية الشيشان الأسبق، «جوهر دوداييف» (1991 ـ 1996)، التيار «السلفي ـ الوهابي»، حيث «راهن على المُنظمات الإسلامية الدولية» في «إحياء الإسلام» بالشراكة مع الجماعات الإسلامية المُتطرفة: «الجماعة الإسلامية، و»الشباب الإسلامي»، وغيرها من المُنظمات، فسارع إلي إعلان «الجهاد»، في الحرب الشيشانية الأولي، ضد الحكومة الفيدرالية، بعد أن تدفقت إليه جموع المُرتزقة من أفغانستان والمنطقة العربية والدول الإسلامية، وغطَّت «أموال النفط» تكاليف النقل والإقامة والأسلحة والتدريب والمكافآت والمُخيَّمات العسكرية، حتي أصبح ـ في غضون سنتين أو ثلاث ـ كما يذكر الكاتب «مُعظم قادة الشيشان من أتباع «السلفية ـ الوهابية»
وهكذا ، فقد انتشر سرطان التطرُّف، واتسعت دوائره في الأطراف الرخوة للإمبراطورية السوفييتية، التي كانت تُعاني من موجات التفكك والتحلل بفعل مؤامرات ومناورات داخلية وخارجية، واستفحل أمر جماعات العنف المُسَلَّح، المدعومة ـ مادياً، وأدبياً ـ بشكلٍ مباشر، من المملكة السعودية، وفي الوقت الذي شهد شلل الإرادة الروسية إزاء هذا الأمر، وإحجامها عن التدخُّل المباشر لوقف تَغَوُّل هذه الجماعات «السلفية ـ الوهابية»، وتهديدها الوجودي لأمن الدولة ووحدة أراضيها، خشية إغضاب الطرف السعودي (!)، سادت، في النصف الثاني من التسعينيات، القوي الأكثر تطرُّفاً، والتي حملت راية «الجهاد المُسَلَّح ضد الدولة الفدرالية، داخل الحركات السلفية، في «داغستان» ومُعظم مناطق القوقاز الأخرى»!
أفغانستان: مصيدة «الدب الروسي»!
وأياً كانت الأوضاع في روسيا، فهي، في الأساس، دولة «عُظمي سابقة»، و «كُبري» حالية، وواحدة من أرفع دول العالم امتلاكاً للتكنولوجيا المُتقدمة، ولديها ترسانة هائلة من الأسلحة النووية والصاروخية، وإحدى أكبر الدول المُصَنَّعة للسلاح، وواحدة من الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، وقد خرج الاتحاد السوفييتي، بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، فائزاً ومُعتزَّاً بتضحياته الكبيرة، وبدوره المشهود في هزيمة الفاشية، وأصبحت الدولة السوفييتية الخصم الأساسي للمعسكر الرأسمالي الغربي بقيادة الولايات المتحدة، ولعبت دوراً مذكوراً في دعم «حركات التحرُّر الوطني» التي نادت بالتخلُّص من نير الاحتلال الأجنبي، ونهبه لثرواتها، وهو ما دعا المعسكر الغربي لحشد قواه، من أجل اسقاط هذا الخصم المرهوب الجانب، وكان أحد أقوى أسلحته في تحقيق هذه الغاية، استخدام سلاح الدين (الإسلامي)، لتفكيك لُحمة هذه الدولة القوية والخصم العنيد، وهدم بُنيانها، وقد تنبه «جون فوستر دالاس»، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، في كتابه «الحرب والسلام» لخطورة سلاح الدين في تفكيك الدول والشعوب، ولفت الأنظار إلي أهمية استغلاله في مواجهة العدو الجديد، بعد هزيمة الفاشية والنازية: «الخطر الأحمر» أو «الشيوعية»!
وكان التدخُّل السوفييتي في أفغانستان، فرصة تاريخية للمعسكر الغربي، من أجل «اصطياد الدب الروسي»، وجرّه إلى «فيتنامه» الخاصة به، وجرى بتعاونٍ كاملٍ بين نظام الرئيس السادات، والولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ونُظم رجعية وتابعة أخري، دعم أمراء الحرب الأفغان، من كبار تُجَّار السلاح والمهربين ومافيا الأفيون والمُخدرات، والذين تحوَّلوا ـ بقدرة قادرـ إلى «مجاهدين»، ومُدافعين عن حوزة الدين الحنيف! حيث تنادوا لمواجهة «جيش الإلحاد السوفييتي»، في الأراضي الأفغانية، ولعبت جماعة «الإخوان المسلمين»، المُتحالفة مع نظام السادات، والملكية السعودية، وجهاز الـ (C.I.A) الأمريكي، والمخابرات الباكستانية، دوراً مهماً في توريد وتدريب «الأنفار»، وقود الحرب، من مصريين وعرب، ومسلمين من شتّي البقاع الإسلامية، ومنهم من أتى من دولة «الاتحاد السوفييتي»، التي كانت قد بدأت في التصدُّع، وتعاني من مظاهر الانهيار!
غير أن تراجع أوضاع الدولة السوفييتية، فالروسية، شمل مواجهة أجهزة الأمن لبروز هذه الظاهرة، حيث أعجزها تراكم أسباب التحُّلل عن استكمال المواجهة، وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي، وجدت الجماعات الإرهابية (الدينية) مرتعاً خصباً للتحرُّك، دون عوائق تُذكر، كما يشرح الكتاب، «حيث أضعفت سياسة «البيريسترويكا» (إعادة الهيكلة) الحدود الخارجية للبلاد، وأضعفت أيضاً الحالة الأمنية الداخلية للبلاد، فتسلل أمراء «السلفية ـ الوهابية» من خلال أفغانستان، الذين أسسوا خلاياهم في طاجكستان ووادي فرغانة»، واستباحوا حُرمات الدولة، وانفردوا بجانب من أطرافها، بل وتجرأت بعض مناطقها ـ بتحريض من المال السعودي والسلاح الأمريكي والغربي، علي إعلان «الاستقلال»! وكان من المُلاحظ، كما يرصد الكاتب، في إشارة مُهمة ولها دلالتها، أن تركيز الإسلاميين على النشاط “يبدو أكثر في مناطق النفط والغاز: منطقة «يامالونينيتس»، الذاتية الحُكم، ومنطقة «خانتي مانسي» الذاتية الحكم، ومنطقة «تيومين»!
فراغ أيديولوجي يملأه الإرهاب!
فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي. كما يذكر الكتاب، «حدث فراغ أيديولوجي كبير، بعد إلغاء الأيديولوجية الشيوعية. حتى الإسلام التقليدي لم يستطع سد هذا الفراغ في المناطق السُكَّانية الإسلامية في شمال القوقاز ومحيط نهر الفولجا». وهو ما سمح بتمدد التيارات الإرهابية والتكفيرية، ورصدت أجهزة الأمن في «منطقة شمال القوقاز الفيدرالية»، إن حوالي سبعة آلاف روسي ومُهاجر من دول «رابطة الدول المُستقلة» يُقاتلون إلى جانب «داعش»، في نهاية عام 2015، أعلنت وزارة الداخلية في داغستان أن حوالي 900 من سُكَّان داغستان كانوا يُقاتلون إلى جانب المُقاتلين في سوريا، وأُعلن في الشيشان، إنه في المجموع انضم حوالي 500 شيشاني إلى «داعش»؛ أمّا وزارة الشؤون الداخلية، فقد أعلنت في مارس 2016، أن 3417 مواطناً روسياً يُقاتلون إلى جانب «داعش»، ومئات آخرون في مجموعات خارج «داعش». وهكذا، «كان المواطنون الروس يُشَكِّلون واحدة من أكبر فرق المُقاتلين الأجانب في سوريا والعراق».
توارت «الماركسية».. فلتحيا «الوهابية»!
ويذكر الكاتب تصريح العالِم الإسلامي «رمضان دجباروف» الذي يقول فيه أن: «بيروسترويكا» الحياة الدينية في روسيا، تزامنت مع افتتاح السفارة السعودية في موسكو، على عهد «بوريس يلتسين»، ومع انهيار الاتحاد السوفييتي، عام 1991، حيث «بدأت السفارة في جذب العديد من الصناديق والمنظمات السعودية للعمل في روسيا. وبحلول عام 1993، افتتحت «مؤسسة إبراهيم بن إبراهيم» و «مؤسسة أحمد الداغستاني» و «منظمة التضامن الإسلامي» و «مدرسة الملك فهد» و «جمعية الشامل» وغيرها، فروعاً في موسكو ومدن أخرى. مما أدى إلى تأسيس نفوذ سعودي حقيقي في القوقاز وفي روسيا. وخلال هذه العملية تم استيراد ملايين من نسخ القرآن وغيرها من المؤلفات الدينية وتوزيعها مجاناً، وإغداق الأموال على عديد الشخصيات الدينية، وتوقيع عقود مُختلفة لبناء المساجد والمراكز الإسلامية الثقافية، وتنظيم الحج المجاني والدراسة في الخارج وغيرها”.
ويلفت مؤلف الكتاب النظر إلي نشاط رجال الإفتاء الديني، «الذين تلقُّوا تعليماً أو تدريباً في المدارس والمعاهد الإسلامية في المملكة السعودية، مصر، سوريا وتركيا». فقد كان لهم دوراً كبيراً في نشر الأيدلوجية السلفية بين الشباب الروسي المُسلم، بعد عودتهم. “ففي روسيا حوالي 2000 إمام في المساجد، تلقُّوا تعليماً أو تدريباً في الخارج؛ وفي عام 2011، كان هناك أكثر من 3000 طالب روسي في جامعات ومعاهد إسلامية في بعض الدول العربية، والأهم أن الجزء الأكبر من هؤلاء الطلاب، تتراوح أعمارهم بين 20 ـ 25 عاماً». أي في السن المناسب للتأثر والانضواء في التنظيمات الدعوية المُتطرِّفة!
ومع كل مساحة كانت تتواري عنها «الماركسية» في الفكر والتطبيق، في روسيا، كانت تتقدم «السلفية ـ الوهابية» لكي تحل محلها، فالفراغ يستدعي من يملأه، وهو أمر عايشناه في مصر بعد رحيل الرئيس «عبد الناصر»
و «الناصرية»، حيث تقدمت الأيديولوجية المُتَطَرِّفة، «الإخوانية» و «السلفية» لكي تحل محلها!
غياب المناعة الداخلية: العنصر الرئيسي للتراجع والانهيار!
لكن العوامل الخارجية، التي أشرنا إليها، لم تكن وحدها التي يعود إليها جاذبية الأفكار «السلفية ـ الوهابية» للشباب الروسي، بل كانت هناك عوامل داخلية، هي الأساس والأهم، فقد أضعفت مناعة الجسد الروسي، وهيأته للانكسار أمام «الفيروس الإرهابي»، ومَهَّدت الأرضية لزحف هذه الأفكار التكفيرية وانتشارها انتشار النار في الهشيم، ومن أهمها:
أولاً: العامل السياسي: والمُتمثل في مستوى عالٍ من السخط على السُلطة، تاريخياً، في أوساط المُجتمعات المُسلمة في شمال القوقاز، بسبب الاضطهاد الاجتماعي والسياسي؛ ووجود نسبة كبير من سُكَّان هذه المناطق دون سن الثلاثين؛ والغاضبة بسبب هذه الأوضاع.
ثانياً: العامل الاجتماعي: بسبب انخفاض مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكلٍ عام في روسيا، وبشكلٍ خاص في مناطق شمال القوقاز، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، بالإضافة إلى وجود نسبة كبيرة من سُكَّان هذه المناطق تحت خط الفقر. لذلك انتشرت السلفية، كقاعدةٍ عامة، بين الشرائح المحرومة مالياً واجتماعياً من السُكَّان في شمال القوقاز ومنطقة الفولجا.
ثالثاً: العامل الثقافي، والمُتمثل في ارتفاع مستوى أُميِّة سُكَّان شمال القوقاز؛ وانخفاض تأثير دور الدين التقليدي في حياة المجتمع، بحيث لم يعد أمام الشباب الروسي المُسلم سوى طريقين: الأول ـ الصوفية، والثاني ـ السلفية. وبما أن الطرق الصوفية، كانت مُقربة جداً للسُلطة الفيدرالية في موسكو، فلم يجد الشباب المُسلم سوى السلفية كملاذٍ، نظراً لعدم ثقة الشباب في السُلطة السياسية المحلية والفيدرالية.
رابعاً: العامل العقائدي: والمتمثل في بساطة الفكر السلفي وسهولة استيعابه؛ مع جهل اللغة العربية، لغة القرآن والأحاديث النبوية؛ مما يُوَلِّد عدم فهم كامل لمعاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ ويُسهل طرح التفسيرات الدينية التي تخدم أغراض هذه الجماعات.
جريرة «السلفية ـ الوهابية»: اكتشاف مُتأخر!
وبعد المكانة المُتعاظمة التي حظيت بها الجماعات الإسلامية الوهابية والمُتطرِّفة، وجماعة «الإخوان المسلمين» الحاضنة الأساسية لجماعات الإرهاب والتكفير والتطرُّف في العالم، ونفوذها الطاغي، ولعقود طويلة مُمتدة، في المملكة العربية السعودية، (اكتشف!) حُكَّامها، مؤخراً، وبعد أن أدت الدور المطلوب منها، وقامت بالواجب التخريبي غير المسبوق الذي امتد أذاه إلى كل بقاع الدنيا، جوهرها الإجرامي المستور، وكشفوا عن دوافع وأغراض هذا الدور، وبأوامر مَن كانت تتحرك؟، ومَن كانت تخدم بتحركاتها؟، ولأي الأغراض كانت تسعى، في الحقيقة وعلي أرض الواقع، بعيداً عن الادعاءات الدينية المُعلنة، والأهداف الإنسانية المرفوعة؟!
فقد صَرَّحَ ولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان»، في حديثه لصحفية «واشنطن بوست»الأمريكية (25 مارس 2018)، لدى سؤاله عن الدور السعودي في نشر «الوهابية»، المُتهمة بأنها مصدر للإرهاب العالمي، مُعترفاً، بأن «الاستثمار السعودي في المساجد والمدارس حول العالم»، وانتشار الفكر الوهابي في بلاده، يعود إلي فترة «الحرب الباردة»، عندما طلبت دول حليفة من المملكة
(لم يُسَمِّها، وإن كان معلوماً أن في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية)، استخدام «أموالها» لمنع تَقَدُّم الاتحاد السوفييتي في دول العالم الإسلامي، زاعماً أنهم، في المملكة، عملوا «بنيّةٍ حسنة» مع «أي شخصٍ يُمكن أن نستخدمه للخلاص من الشيوعية، وكان من هؤلاء «الإخوان المسلمين»!، ومؤكداً علي اكتشاف المملكة المتأخر جداً: أنه «إذا رأيت أي إرهابي سترى أنه من جماعة «الإخوان المسلمين»، وإذا رأيت «أسامة بن لادن»: كان من جماعة «الإخوان المسلمين»، وإذا رأيت «البغدادي» زعيم «داعش» فهو من «الإخوان المسلمين»!.
وأضاف: «إن مدارسنا قد تم غزوها من جماعات مُتشددة، كـ «الإخوان المُسلمين»، وقريباً سيتم القضاء عليها، ولن تقبل أي دولة في العالم أن يكون هناك جماعة مُتطرِّفة مُسيطرة على النظام التعليمي».
وحتي باكستان، وبعد الدور المشهود الذي لعبته، في استقدام، واستقبال، وتنظيم، وتدريب عصابات الإرهاب، التي تدفَّقت من كل حدب وصوب إلي معسكرات التجهيز بمقاطعة «بيشاور» علي الحدود مع أفغانستان، الممولة سعودياً، والمُسَلَّحة من المخابرات الأمريكية “C.I.A”، إعداداً لـ «الجهاد» ضد القوات السوفييتية «المُلحدة»، اعترفت بأن هذا الأمر لم يدفع الأوضاع خطوةً واحدةً إلي الأمام، بل أن الجنرال «مُشَرَّف»، الرئيس الباكستاني الأسبق، يعترف في حديث صريح لـ «B.B.C»، عام 2002: «الآن نحن المسلمين الأكثر فقراً، والأكثر جهلاً، والأكثر تخلفاً، والأكثر فساداً، والأقل تنويراً، والأكثر حرماناً، والأضعف في كل جنس من البشر»!!
«فلاديمير بوتين»: بداية التصدّي!
ومن المؤكد أن وصول «رئيس جهاز الأمن الفيدرالي»، «فلاديمير بوتين»، إلى موقع رئيس الحكومة، في أواخر عام 1999، فموقع رئيس الدولة، خلفاً لـ «بوريس يلتسين»، عام 2000، كان إيذاناً بتغيير كبير، على المستوى الداخلي، تَمَثَّلَ في السعي لإعادة بناء الدولة، وإحكام السيطرة على أطرافها المُفَكَّكة، ومحاربة عصابات المافيا والفساد، … إلخ، وعلى مستوى لا يقل أهمية، استعرَّت المواجهة ضد تيارات التطرُّف والعنف الديني، أو ـ بصورة أدق ـ مع الجماعات «السلفية ـ الجهادية»، التي عرَّضت الدولة الروسية لخطرٍ حقيقيٍ داهم!
نظرت الدولة الروسية، بقيادة «فلاديمير بوتين» إلي العلاقات مع المجتمع الإسلامي، بصفتها «قضية وطنية حيوية يعتمد عليها مستقبل روسيا»، وميَّزت بين «الدين» (الذي يحث على التسامح والالتزام بتعاليم القرآن، ويحترم العادات والتقاليد المحلية لكل منطقة داخل روسيا) وبين «الإرهاب»، ففي حين أعلنت، كما صَرَّحَ الرئيس «بوتين»، في سبتمبر 2015: «إن الإسلام التقليدي جزء لا يتجزأ من الحياة الروحية لبلادنا»، فإنها اعتبرت «الإسلام الراديكالي»، أو «الإسلام السياسي»، أو «الإسلام الجهادي»، أو «السلفية ـ الوهابية»، بكافة مُترادفاتها، عدواً «تقف أمامه كل سُلطات الدولة الروسية السياسية والأمنية».
التعريف الروسي لـ «السلفية ـ الوهابية»
فـ «السلفية ـ الوهابية»، بالمنطق الروسي، كما يشرح الكاتب، هي تيار غير مُتجانس للغاية. يمكن تعريف مجموعاتها الرئيسية على النحو التالي: «الوهابيون “الكلاسيكيون»، الذين يُطلقون على أنفسهم السلفيين
(أتباع «صف الإسلام» أو «الإسلام النقي»)؛ «الإخوان» أو «الإخوان المُسلمون»؛ «الحزبيتوف» ـ (الحزبيين، وهم أنصار «حزب التحرير الإسلامي» الإرهابي)،
و«التبليغيين» (أتباع الطائفة الباكستانية المُتَطَرِّفة «جماعة التبليغ»). فإذا كنت إرهابي أو إخواني أومن أنصار «حزب التحرير» أومن «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، فأنت «سلفي ـ وهابي» في الأساس. وتبرز «السلفية ـ الوهابية» الروسية في شكل السلفية المُتطرِّفة، «التي تُساوي جميع مؤيدي الإسلام التقليدي مع غير المُسلمين، فكلاهما كُفَّار». وتنتشر السلفية المُتطرِّفة الجهادية بشكل أساسي في شمال القوقاز، والتي تخوض حرباً مُستمرة حتى الآن ضد السُلطات المحليّة والفيدرالية، وضد الإسلام التقليدي وممثلي الطُرق الصوفية. وفي آخر 5 سنوات يُمَـثِّلُ هذا التيار السلفي (طِبقا للمفهوم الروسي) أعضاء «تنظيم الدولة الإسلامية»، (داعش)، والذي تنتشر خلاياه النائمة بشكلٍ واضح في مناطق كثيرة داخل الاتحاد الروسي وغير مقتصر على مناطق شمال القوقاز.
ويمكن أن نراها في شكل «السلفيين المُعتدلين» (ظاهرياً)، والذين يؤيدون استمرار الجمهوريات الإسلامية الروسية داخل الاتحاد الفيدرالي، وينبذون العنف بكل أشكاله، والذين يُرَكِّزون فقط على الدعوة ونشر الأفكار السلفية في المجتمع. إلّا أن «من وجهة النظر الأمنية والحفاظ على تماسك المجتمع، فكلا المجموعتين تُمثلان خطراً كبيراً. فالمُعتدلون فقط ينتظرون. ولكن في أي لحظة يمكن أن يتحوّلوا إلى العنف. فلا توجد سلفية معتدلة أو غير معتدلة، فـ «السلفية ـ الوهابية» خطر واضح على المجتمع الروسي وعلى الفيدرالية الروسية، بسبب أنها في الواقع أيديولوجية لا تقبل القيّم والتقاليد الوطنية،
أو التمسُّك بالمذاهب أو قيّم عقيدية أخرى».
الصفقة الكبرى!
واستطاعت السُلطات الروسية، بجهدٍ موجّه، ومُمَنهجٍ، ومُنَظَّم، أن تُجري ما يُمكن توصيفه بـ «صفقة كُبرى»: «فقد منحوا الحقوق والحريات للمسلمين، ويتم احترامهم، ويحصلون علي دعم الدولة، شريطة أن يكونوا موالين بشكلً كامل لها»، وبذلك استطاعت أن تعزل، إلي حدٍ ملموس، القاعدة الشعبية المُسلمة الواسعة والسريعة النمو، عن الجماعات الإرهابية والتكفيرية «الوهابية»، بعد أن كانوا يُشكلون تهديداً بالغاً لأمن الدولة ووحدتها، مثلما كان الحال عام 1998، حينما استطاع «الوهابيون» الاستيلاء علي السلطة في منطقة «قادار»، «وشكَّلوا فعلاً «دولة مُصَغَّرة تُطبق ما يدعونه «الشريعة الإسلامية»، بداخلها، وذلك بدعمٍ واضح من المؤسسات (الخيرية) العربية (والسعودية والخليجية أساساً)، وجماعات الجريمة»!
البرنامج الروسي للحرب على الإرهاب
الإطار القانوني والتشريعي
تحظر المادة 13 من الدستور الروسي: «إنشاء الجمعيات العامة ذات الأهداف والأنشطة الموجّهة نحو التغيير القسري لأساس النظام الدستوري وانتهاك سلامة الاتحاد الروسي، أو تقويض أمنه، أو إنشاء وحدات مُسَلَّحة، أو التحريض على الفتنة الاجتماعية أو العرقية أو القومية أو الدينية، وكذلك تُحظر أنشطتها»، أمّا الفقرة الثانية من المادة 29 من الدستور فتنص على: «الدعاية أو التحريض اللذان يُثيران الكراهية والعداء الاجتماعي أو العرقي أو القومي أو الديني محظوران. والدعاية للتفوّق الاجتماعي أو العرقي أو الوطني أو الديني أو اللغوي محظورة أيضاً».
أمّا القانون الفيدرالي رقم 125 الصادر في 26 سبتمبر 1997، «قانون حرية الضمير والجمعيات الدينية»، فينص في المادة الرابعة على «الاتحاد الروسي دولة علمانية. لا يمكن تأسيس أي دين للدولة أو دين إجباري. يتم فصل الجمعيات الدينية عن الدولة وتكون متساوية أمام القانون». وفي الفقرة الخامسة من نفس المادة «يحظر على الجمعيات الدينية أن تؤدي وظائف السُلطات العامة والهيئات الحكومية الأخرى ومؤسسات الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلية؛ لا تُشارك في الانتخابات للسُلطات العامة وهيئات الحُكم الذاتي المحليّة؛ لا تُشارك في أنشطة الأحزاب السياسية والحركات السياسية ولا تُقَدِّمُ لها مُساعدات مادية أو غيرها».
وبالنسبة للقانون الفيدرالي رقم 25 الصادر في 11 يوليو 2001، «قانون الأحزاب السياسية»، فيحظر في مادته التاسعة تأسيس الأحزاب على أساس ديني. كما ينص «قانون العقوبات الروسي» أيضاً، في مادته «63»، على أن أى جريمة جنائية تُرتكب بدافع الكراهية الدينية، تُعامل كظرفٍ مُشَدَّدٍ للعقوبة.
هناك أيضاً بعض القوانين المحليّة في جمهوريات الاتحاد الروسي التي سُنَّت لمُكافحة التَطَرِّف الديني (قانون جمهورية داغستان المُتَعَلِّق بحظر الوهابية، الصادر في 22 سبتمبر 1999، قانون «قبردينو ـ بلقاريا» الصادر في 1 يونيو عام 2001 بشأن حظر الأنشطة الدينية المُتَطرِّفة).
من مُكافحة «الإرهابيين والأنشطة الإرهابية»
إلي مواجهة «الفكر والأيدلوجية الإرهابية»
ومن المُلاحظ، كما يرصد الكاتب، أن هذه المواد الدستورية والقوانين، ركَّزت على «مكافحة الأنشطة الإرهابية وحسب، وليس مُكافحة الأيديولوجية أو الفكر الإرهابي، وهو الأخطر والأصعب في المُعالجة، ولذلك، فقد تم استدراك هذا النقص، عبر القانون الفيدرالي رقم 35 لعام 2006 «حول مكافحة الإرهاب»، كأول وثيقة قانونية مذكورٌ فيها العمل الوقائي في إطار تنظيمي إستراتيجي لمواجهة الأيديولوجيات الإرهابية والمُتَطرِّفة؛ ونصوص هذا القانون تصف الطرُق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية لحل المُشكلة.
أمّا في عام 2009، فقد ظهرت وثيقة سياسية ـ قانونية، تحت مُسَمَّى «مفهوم مكافحة الإرهاب»، الذي صاغ التدابير الوقائية الرئيسية، مثل التنمية السياسية، وتعزيز التعاون الدولي؛ النمو الاجتماعي والاقتصادي؛ تنفيذ مبدأ حتمية العقوبة على الجرائم ذات الطابع الإرهابي؛ دعم التواصل الإيديولوجي لتدابير مكافحة الإرهاب؛ تعزيز القيّم ذات الأهمية الاجتماعية؛ تهيئة الظروف للحوار السلمي بين الأعراق والأديان.
وقد اعتُمد القانون الفيدرالي رقم 302 لعام 2013، «بشأن تعديل بعض القوانين التشريعية للاتحاد الروسي»؛ وجرى استكمال القانون الجنائي لروسيا بعددٍ من المواد القانونية الجديدة، التي تُطور وتُحَدِّدُ العديد من أحكام الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الإقليمية الخاصة بمكافحة الإرهاب.
فتم إضافة تعديل للمادة 205 من القانون الجنائي الروسي، وهذا التعديل خاص بـ «التدريب بغرض القيام بأنشطةٍ إرهابية»، فمُجرد التدريب على تنفيذ أيٍ من الجرائم الخاصة بالإرهاب في المواد: 206 الخاصة باختطاف رهائن؛ 208 الخاصة بتنظيم تشكيل مُسَلَّحٍ غير قانوني؛ 277 الخاصة بالاعتداء على رجال الدولة الحكوميين؛ 211 الخاصة باختطاف أي وسيلة نقل رُكَّاب؛ المادة 278 الخاصة بالاستيلاء القسري على السلطة؛ المادة 279 الخاصة بالتمرُّد المُسَلَّح؛ والمادة 360 الخاصة بالهجوم على أشخاص أو مؤسسات تتمتع بالحماية الدولية، يضع الشخص تحت المسائلة القانونية الكاملة المذكورة في هذه المواد.
وتنص قائمة مواد القانون الجنائي الروسي هذه على مسؤولية ارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك اكتساب المعرفة والمهارات العملية أثناء التدريب البدني والتحضير النفسي، عند دراسة أساليب ارتكاب هذه الجرائم، وقواعد التعامل مع الأسلحة والأجهزة المُتفجِّرة، السامة، وكذلك المواد والأشياء الأخرى التي تُشكل خطراً على الآخرين. تُثبت المسؤولية عن هذه الأفعال في شكل عقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وبغرامة تصل إلى خمسمائة ألف روبل أو بمبلغ الأجر أو دخل آخر للشخص المُدان لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وبذلك يكون في حوزة الاتحاد الروسي، ترسانة تشريعات قوية تساعد الأجهزة الأمنية في مكافحة الفكر المُتَطَرِّف ومُكافحة الإرهاب.
لكن؛ بالإضافة إلى «الإطار القانوني والأمني» السابق، وضعت الإدارة الفيدرالية برنامجاً للعمل علي المستوي الثقافي والأيديولوجي، من أبرز ملامحه:
التركيز على ترسيخ قوعد التعليم الوطني الروسي المُوَحَّد، والتأكيد، في جميع البرامج المدرسية، على التسامح بين الأعراق، ونشر ثقافة المواطنة والانفتاح الفكري والعقائدي، من خلال أنشطة التوعية الجماهيرية، والتي تُجرى في شكل لقاءات شخصية، ومُحاضرات من قِبل المسؤولين عن إنفاذ القانون والمدرسين والزعماء الدينيين والناشطين المدنيين، وكذلك من خلال الصحافة المحلية والإنترنت والمنشورات والكُتيبات. ومن خلال تصوير الأفلام الوثائقية ومقاطع الفيديو حول هذا الموضوع. بالإضافة إلى التوعية الجماهيرية، والاهتمام بالعمل المُستهدف مع المُراهقين المُعرضين للخطر، لا سيَّما من الأُسر المحرومة اجتماعياً، غير المُكتملة والضعيفة، وكذلك من أُسر الإرهابيين السابقين الذين قضوا فترات عقوبتهم، أو الإرهابيين النشطين، أو الذين لقوا حتفهم (تعتبر أراملهم وأطفالهم ضعفاء بشكل خاص). كما يتم القيام بعملٍ هادفٍ مع المواطنين الذين يعتبرهم مسؤولو تطبيق القانون مُتعاطفين مع الأيديولوجية المُتَطَرِّفة، ومع الأشخاص الذين تلقُّوا التعليم الديني في الشرق الأوسط (وضمنه تقع الدول العربية ومصر!).
ومن النقاط المُهمة في هذا السياق، تضمُّن البرنامج رفع المستوى التعليمي للأئمة المحليين، و «تنظيف» صفوفهم من العناصر «السلفية ـ الوهابية» الصريحة، ودعم مجلس المُفتين في روسيا، وغيرها من الهياكل التي تدعو إلى الإسلام التقليدي لتدعيم أنشطتهم وجهودهم، ودعم بعض رجال الدين الوسطيين، والذين لديهم سمعة طيبة بين الشباب والأجيال الجديدة.
كذلك فقد تضمَّن البرنامج تكوين مجموعات إليكترونية، تضم مُتخصصين يعملون بدوامٍ ثابت، من أجل مواجهة المواقع الإليكترونية المُتَطَرِّفة، وإثبات كذبها وتزييفها للحقائق.
وإضافةً إلى ما تقدَّم، فقد اهتم البرنامج بتحديد الإطار الاجتماعي المُكَمل لهذا الخط، وأهم ما فيه هو التأكيد على أن يكون هناك سياسة اجتماعية واقتصادية مدروسة تُحَقِّقُ للشباب الذات، وعلى المستوى الاجتماعي والمادي والروحاني. وتعالج أسباب القصور في المستوى الاقتصادي ـ المعيشي المتواضع، لمُعظم الشباب الذي يعيش في جمهوريات شمال القوقاز ومع إدراك أن هذا ليس السبب الحقيقي والوحيد للتطرُّف؛ إلّا أنه عاملٌ مهمٌ جداً، يساعد على انتشار الأفكار المُتَطَرِّفة بين الشباب المُسلم، وحتى غير المسلم، في روسيا.
الوصية الختامية!
ويُنهي الكاتب بحثه القيِّم بمجموعة من الاستخلاصات النهائية، أو الدروس المُستفادة، من «المعركة الروسية» ضد جماعات الإرهاب، يُلَخِّصُ ـ من خلالها ـ أهم ما يتوجب الانتباه له، حتى يُمكن محاصرة «الظاهرة الإرهابية»، وتقليل آثارها الضارة، إلى أبعد مدى، وعسى أن يوجد فيها ما يُفيدنا، في معركتها المصيرية ضد هذه جماعات التكفير والتطرُّف والتخريب والإرهاب، ومن يقف خلفها، فيقول:
«هناك عوامل تُساهم بشكل كبير في زيادة انتشار الأفكار المُتَطَرِّفة، وهذه العوامل يُمكن حصرها في الآتي: تعسُّف المسؤولين؛ الفساد؛ حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أيدي المُوظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛ البطالة والطبقية الاجتماعية العميقة للمجتمع؛ عدم وجود خطط واقعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ عدم كفاءة مؤسسة الحكم؛ عدم كفاءة النظام الانتخابي كآلية لتشكيل الهيئات المُنتخبة، من خلال تفويض الأشخاص القادرين على تمثيل وحماية مصالح ناخبيهم.
فمن الضروري القضاء على هذه العوامل بفعاليّة، من خلال إدخال إجراءات أكثر ديمقراطية بموجب القانون، وإرساء سيادة القانون، وضمان اللامركزية المعقولة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشغيل الشباب، وتحسين نوعية الخَدمات العامة، وخاصة التعليم.

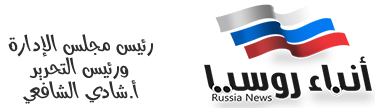 وكالة أنباء روسيا الإخبارية
وكالة أنباء روسيا الإخبارية



